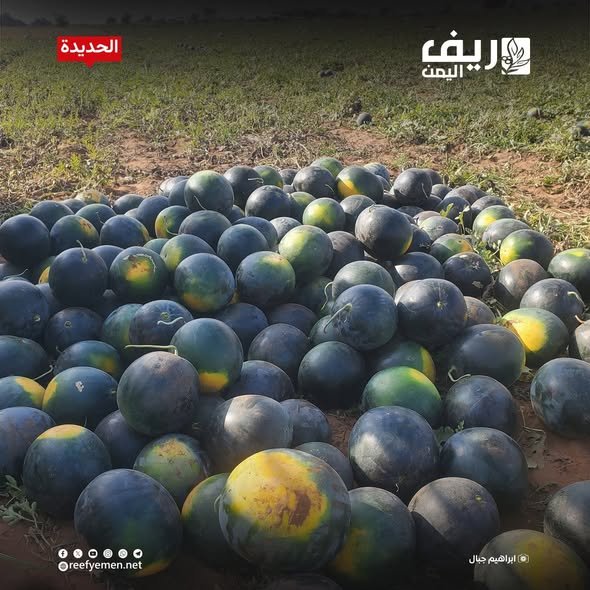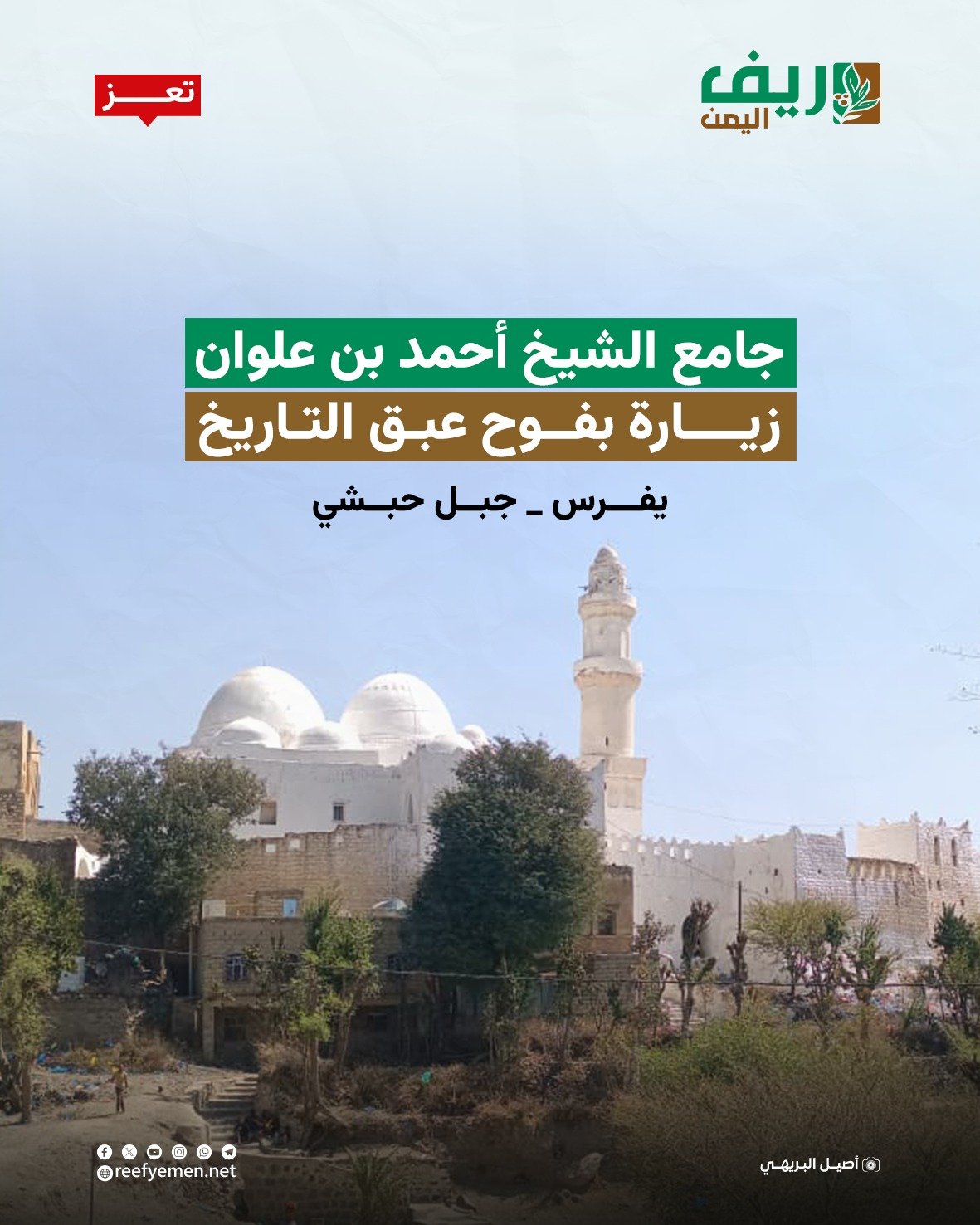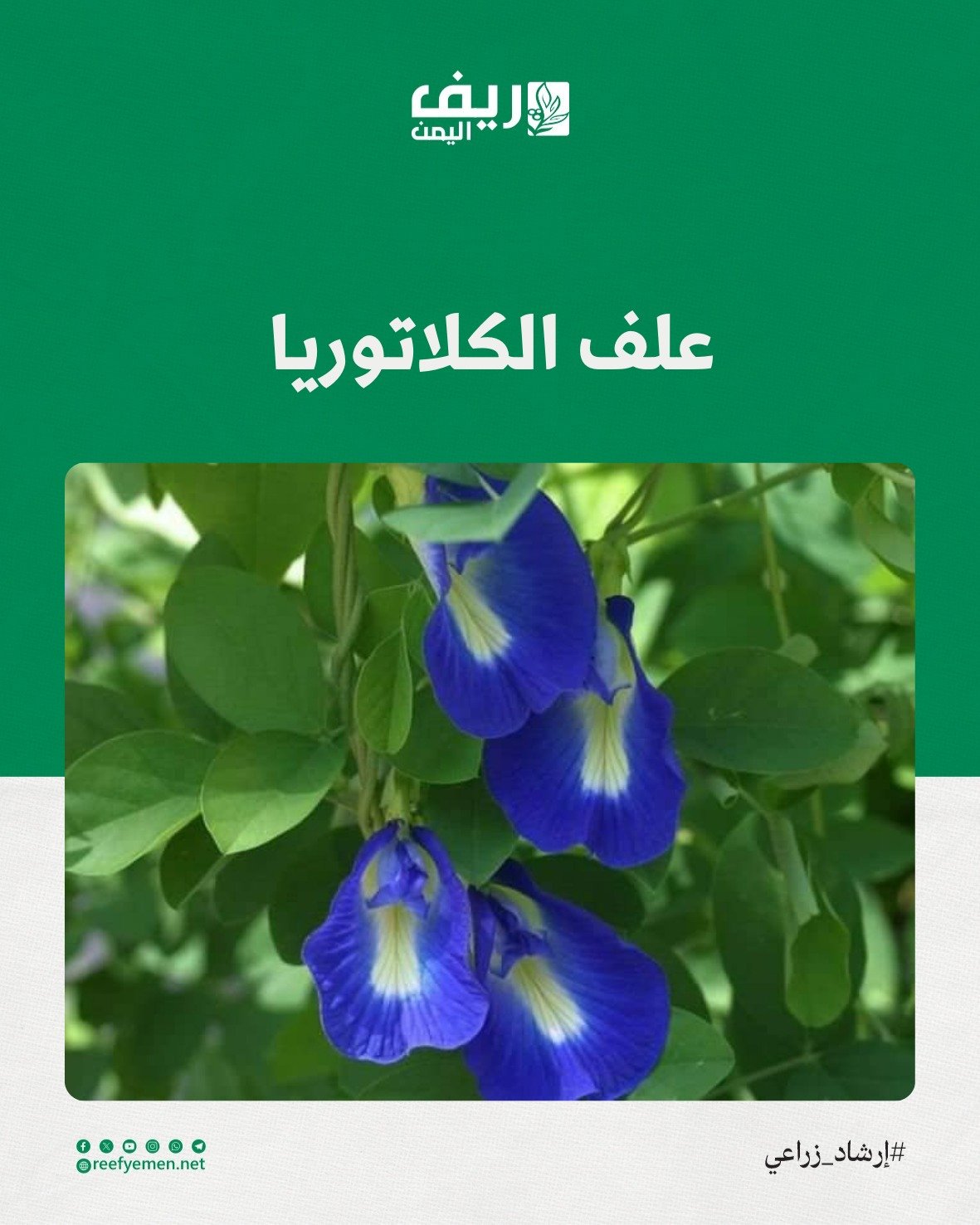تعاني ‹أم ناصر› مع أطفالها الخمسة في إحدى مخيمات النزوح، حيث تستخدم حمّام مؤقت يكسوه الصدأ وتنبعث منه رائحة نفّاذة، وتضطر لاستخدام الحمّام المشترك رغم تراكم المياه الملوثة حوله، وهو ما يسبب أمراض باستمرار لأطفالها.
لا يختلف حالها عن كثير من النساء اللواتي يواجهن أخطار صحية صامتة بسبب عدم وجود خدمات صرف صحي آمنه في مخيمات النزوح حيث تنتشر المستنقعات التي وأصبحت مصدر عدوى تنتشر من خلالها الأمراض.
وقالت أم ناصر -النازحة في إحدى مخيمات مأرب- مشاكل الصرف الصحي لا تنتهي مع طول فترة النزوح منذ ثمان سنوات ‹والحل هو ان نعود إلى منازلنا وان تنتهي هذه الحرب التي دمرت كل حياتنا›.
ومع انعدام الإضاءة ليلاً في غالبية مخيمات النزوح، تزداد المخاوف من استخدام الحمّامات المؤقتة التي في بعض الحالات تشترك فيها عدد من الأسر، ما يدفع بعض النساء إلى تجنّبها تمامًا، فيؤثر ذلك على صحتهن.
‹أم أكرم› نازحة من الحديدة في أحد مخيمات سهدة بالضالع تقول لـ‹ريف اليمن›: ‹نضطر نروح الحمام في الليل وسط الظلام، نخاف على بناتنا، والمسافة بعيده لكن لا يوجد لدينا بديل› وتمتنع أحيانا بسبب الخوف وتقول ‹أهم شيء نحافظ على سترنا›.
مواضيع مقترحة
- مياه الصرف الصحي والنفايات.. قاتل يتفشى بالأرياف
- مأرب.. صقيع الشتاء يضاعف معاناة النازحين
- أطفال الريف.. بين قسوة النزوح وآثار التغير المناخي
مشاكل الصرف الصحي
تعاني مخيمات النزوح من عشوائية بإدارة مياه الصرف الصحي وتتفاوت الخدمات بين مخيم وآخر، وتواجه آلاف الأسر النازحة واقعًا قاسيًا، إذ تتحول الحمامات المؤقتة إلى بؤر ملوثة ومصدر للأمراض.
يقول إسماعيل ثابت، مسؤول قسم المياه والإصحاح البيئي في الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب، ‹الوضع في مجال المياه والإصحاح البيئي داخل المخيمات حرج للغاية، ويمثل أحد أبرز الاحتياجات الأساسية للنازحين›.
وتعتمد الكثير من الأسر على حمامات بدائية وهشة مصنوعة من القش والصفيح، أو الأقمشة ولا توفر سوى قدر بسيط من خصوصية، وفق حديث ثابت لـ‹ريف اليمن› وقال: ‹بعض الحمامات التي يتم توزعيها من شركاء العمل الإنساني لها مدة صلاحية محدودة وتتلف›.
إسماعيل ثابت: الوضع في مجال المياه والإصحاح البيئي داخل مخيمات النازحين في مأرب حرج للغاية ونحتاج 1400 حمام مؤقت حالياً
ويوجد نحو 4.8 مليون نازح داخليًا في اليمن، والنسبة الأعلى منهم في محافظة مأرب والتي تضم 212 مخيمًا للنازحين، منها 66 مخيمًا تدار من قبل منظمات وتتوفر فيها حمامات مؤقتة، فيما يعاني 146مخيماً احتياجا حاداً، وتحتاج نحو 1400 حمام مؤقت لتغطية الاحتياج القائم حالياً، وبحسب تقديرات الإصحاح البيئي في مأرب.
وعن تحديات تدهور دورات المياه المؤقتة. يقول ثابت ‹المعيار الدولي الحمام الواحد يستخدمه ما بين 12 إلى 21 فردًا، لكن في مأرب العدد أكبر وتشترك عدة أسر وهذا يسرع من إنتهاء صلاحية الحمامات المؤقتة›.
أزمة ادارة المخلفات
تمثل إدارة مخلفات الحمّامات المؤقتة تحديًا بيئيًا متزايدًا في مخيمات النزوح، بسبب عدم وجود بنية تحتية للصرف الصحي، فمثلاً في مأرب تستخدم حُفرٍ بدائية عشوائية «بيارات» ومن ثم تُنقل إلى مناطق مفتوحة، ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية.
ويوجد في مأرب نحو مليوني نازح يمثلون حوالي 90% من سكان المحافظة التي تفتقر كليًا إلى نظام صرف صحي، والبنية التحتية المتوفرة بالكاد كانت تغطي احتياجات المجتمع المضيف قبل اندلاع الحرب.
وقال خالد الشجني، مساعد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ‹لا يوجد حتى الآن مشروع صرف صحي في مأرب، لذلك تُجمع مخلفات الحمّامات في حُفر عشوائية «بيارات» بعضها تصل عمقها 30 متراً بعضها تشفط عندما تمتلئ وغالبيتها يتم ردمها وإنشاء حُفر أخرى›.
وحذر الشجني في حديث لـ‹ريف اليمن› من كارثة صحية وبيئية وشيكة إذا لم تُعتمد حلول عاجلة، وقال ‹مأرب تعيش اليوم في مستنقع بيئي كارثي ومشكلة الصرف الصحي أصبحت خطيرة جدًا، وتسببت الحُفر العشوائية بحوادث مميتة حيث سقط أطفال فيها ولقو حتفهم›.
في محافظة الضالع «جنوبي اليمن» حيث توجد عدد من مخيمات النزوح تعاني من ذات المشكلة في تصريف المخلفات. وقال رضوان الأكحلي، مدير الوحدة التنفيذية للنازحين ‹كثير من المخيمات يوجد فيها حمامات مؤقتة متصلة بحفر كبيرة «بيارات» وعند امتلائها يتم شفطها بتمويل من منظمات›.
لكن في حال غياب الدعم أو تأخر التدخل تمتلئ البيارات وتفيض بمحتوياتها في المخيمات. وقال في حديث لـ‹ريف اليمن›: ‹هناك أسر تستخدم حمامات مشتركة ما يزيد الضغط على هذه المرافق ويضاعف المخاطر›.
وأوضح الأكحلي ‹بعض البيارات الصغيرة لا تستوعب الاستخدام اليومي وتُصرّف مياهها مباشرة في داخل المخيم، نتيجة عدم وجود بدائل أو خدمات صيانة دورية، وهذا يجعل مشكلة المخلفات مستمرة وتشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا›.
مخيمات النزوح في عبس
في عبس بمحافظة حجة «شمال غربي اليمن» والتي تضم أحد أكبر مخيمات النازحين، يستخدم النازحون حمامات مصنوعة غالبًا من الصفيح أو الخشب أو القماش، ولا يوجد بنية تحتية للصرف الصحي مما جعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض.
وقال الصحفي عيسى الراجحي المهتم بالشأن الإنساني ‹هناك أسرًا بأكملها تصاب بالأمراض المعدية التي تنتشر نتيجة شحة المياه وبؤر البعوض التي تتكاثر قرب الحمامات المكشوفة، مما يزيد حالات الإصابة بالكوليرا، والإسهالات المائية›.
بعض النازحين الذين لا تتوفر لديهم حمامات مؤقتة إضطروا لبناء مراحيض بدائية من القماش والقش، غالبًا في أماكن بعيدة عن الخيام لا توفر الخصوصية للنساء، ما يجعلهن عرضة للتحرش. وفق الصحافي الراجحي.
وقال: ‹بعض الأسر لا تمتلك حمامات إطلاقًا، فيلجأ أفرادها إلى قضاء حاجتهم في الخلاء «مكان بعيد عن السكان» ليلًا، لكن النساء لا يستطعن فعل ذلك وهو ما يتسبب لهن بمشكلات صحية”.
الراجحي: بعض النازحين في “عبس” إضطروا لبناء مراحيض بدائية من القماش والقش في أماكن بعيدة عن الخيام لا توفر الخصوصية للنساء
كما تسبب الحمامات المؤقتة بانتشار الروائح الكريهة داخل المخيمات، وأصبحت مصدر تهديد صحي وبيئي بسبب غياب الصيانة والتخطيط العشوائي لأماكن وضعها. وقال الراجحي ‹إن غياب أنظمة صرف صحي آمنة في الحمامات المؤقتة يؤدي إلى تسرب المياه الملوثة إلى التربة أو مصادر المياه، مما يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا›.
ودعا الصحافي الراجحي المنظمات الإنسانية ‹توفير حلول دائمة وآمنة للصرف الصحي لحماية النازحين والسكان المجاورين للمخيمات من هذه المخاطر›.

مستنقعات قاتلة
تشكل الحُفر العشوائية «البيارات» لمخلفات الصرف في مخيمات النزوح خطرًا مباشرًا وقاتلاً على النساء والأطفال وإحدى مسببات الوفاة، حيث وقعت عدد من حوادث السقوط في المستنقعات المفتوحة بسبب انهيارات مفاجئة أو عدم تأمينها بشكل جيد.
في مخيم الجفينة بمأرب، تُوفيت منال أحمد في مارس 2025، بعد أن خرجت لزيارة قريبتها في المخيم. وقال زوجها عبد الله ناجي لـ‹ريف اليمن› خرجت زوجتي لزيارة أقارب في المخيم ولم تعد وقال ‹بحثت عنها لمدة يومين، قبل أن نعثر على جثتها في إحدى المستنقعات المكشوفة›.
أيضًا توفي الشاب أحمد البازلي في مأرب بإحدى المستنقعات العشوائية عام 2023. وقال شقيقه بهاء الدين البازلي لـ‹ريف اليمن› توفي أخي بعد سقوطه على رأسه في إحدى الحفر الممتلئة بمياه الصرف الصحي.
وفي محافظة الضالع، سقط الطفل يوسف يعقوب أحمد قاسم (4 سنوات) داخل إحدى الحفر العشوائية لمخلفات الصرف الصحي في 18 أغسطس 2025 ونجا من الموت بأعجوبة، بعد أن تم إسعافه بسرعة إلى المستشفى الميداني في المخيم.
المخاطر الصحية
وتتزايد المخاطر صحية التي تهدد حياة النازحين خصوصًا النساء والأطفال في ظل غياب أنظمة صرف صحي آمنة، والاعتماد على الحمامات المؤقتة، ويُحذر أطباء من أن سوء إدارة هذه الحمّامات وعدم الإلتزام بالمعايير يجعلها خطرًا صحيًا.
ورأت الدكتورة منال العوكبي، طبيبة الأطفال المتخصصة في عدن، إن الحمّامات المتنقلة في مخيمات النزوح ‹قد تتحول إلى بؤر لنقل العدوى والأمراض المعدية نتيجة سوء النظافة وضعف إدارة الصرف الصحي›.
منال العوكبي: النساء والفتيات خصوصًا في سن المراهقة والإنجاب معرضات للإصابة بأمراض تناسلية نتيجة استخدام الحمامات المشتركة
أبرز تلك المخاطر الصحية تهدد الأطفال بالأمراض المعوية مثل الإسهالات الحادة والتيفوئيد الناتجة عن تلوث المياه أو ملامسة الأسطح الملوثة بمخلفات بشرية، ما قد يؤدي إلى الجفاف وسوء التغذية، وفق حديث العوكبي لـ‹ريف اليمن›.
وقالت: ‹النساء والفتيات خصوصًا في سن المراهقة والإنجاب، معرضات للإصابة بأمراض تناسلية مثل التهابات المسالك البولية والفطريات المهبلية نتيجة استخدام الحمامات المشتركة›، بالنسبة للأطفال فإن تراكم الأوساخ والرطوبة حول الحمّامات يسبب ‹انتشار الأمراض الجلدية كالجرب والتهابات البشرة والفطريات›.
وتوضح العوكبي ‹هذه المخاطر تتضاعف في ظل ضعف الوعي الصحي ونقص احتياجات النظافة الشخصية› ودعت إلى ضرورة توفير برامج توعية صحية ومراقبة دورية تضمن سلامة استخدام الحمّامات المؤقتة للتقليل من احتمالات تفشي الأوبئة داخل المخيمات.

التأثيرات البيئية والاجتماعية
تعد الحمامات المتنقلة حاجة لحفظ الكرامة الإنسانية لكنها وبدون مراعاة معايير صحية تؤثر بشكل عكسي على مجتمع النازحين نفسيا واجتماعيا، وتمتد أضرارها إلى البيئة المحيطة بمخيمات النزوح.
يقول الخبير في شؤون العلوم والبيئة، عمر الحياني ‹تُقدّم الحمّامات المتنقلة في مخيمات النازحين، حلولًا مؤقتة مهمة تحافظ على كرامة الإنسان والنظافة العامة، وتمنع التلوث وتحمي التنوع الحيوي من الانتهاك أو التدهور›.
لكن لهذه المرافق جانبًا سلبيًا، خصوصًا في مخيمات النازحين -وفق حديث الحياني لـ‹ريف اليمن›- حيث قد تتحول إلى بؤر لنقل الأمراض وتلوث التربة والمياه. وقال: ‹من الضروري استخدام الحمّامات المؤقتة بحذر، وضمان صيانتها بشكل دوري لتقليل المخاطر›.
من جانبه اعتبر، الباحث الاجتماعي صالح الباخشي، الحمامات المؤقتة المشتركة للنازحيين بأنها تمثل أحد أبرز القضايا الإنسانية الحساسة ‹إذ تُستخدم من قبل جميع سكان المخيم دون تمييز، ما يجعلها انتهاكًا صامتًا لخصوصية وكرامة الإنسان›.
وقال لـ‹ريف اليمن›: تفتقد النساء والفتيات الأمان والخصوصية أثناء استخدام الحمامات المشتركة، وهناك ضرورة لتهيئة بيئة آمنة تحافظ على كرامة الإنسان في هذه المخيمات.
ويؤدي طول أمد النزوح إلى بروز عدد من المشكلات الاجتماعية والنفسية. وقال الباخشي ‹إن المعاناة في مخيمات النازحين المكتظة تؤثر بعمق على سلوكيات الأفراد وتماسكهم الاجتماعي مما ينتج عنه ظواهر مقلقة ومزعجة›.
يضيف الباخشي ‹إن صعوبة التكيف مع المكان والظروف القاسية تخلق بيئة مضطربة، وهذا يدفع بعض الشباب إلى الانحراف السلوكي كوسيلة للهروب أو للتعبير عن الغضب المكبوت›.
استجابة السلطات والمنظمات
تحدثت منصة ‹ريف اليمن› إلى مسؤولين في الحكومة الشرعية والمنظمات العاملة في اليمن عن طرق الإستجابة لمشكلة الصرف الصحي في مخيمات النزوح. وقال المهندس حسام غيثان، مدير وحدة المياه الإصحاح البيئي بوزارة المياه ‹إن الحمامات المتنقلة يُفترض أن تكون حلًّا مؤقتًا لا تتجاوز مدته ستة أشهر، لكن نظرًا لظروف البلد تستخدم لفترات أطول›.
ويضيف لـ‹ريف اليمن›: نواجه تحديات تتعلق بجودة الحمامات المنفذة من قبل بعض الشركاء ‹إذ ترى بعض المنظمات أن الحل الأسرع في مناطق النزوح هو إنشاء حمامات بدائية تتناسب مع طبيعة المنطقة›.
وعن العشوائية في تصريف المخلفات. قال غيثان ‹نحرص قدر الإمكان على إلزام المنظمات توفير تصريف مناسب للحمامات المؤقتة، سواء عبر ربطها بشبكات الصرف الصحي المعتمدة، أو ضمان نقل وتصريف المياه إلى أماكن آمنة›.
الأشول مسؤول الاعلام بالهجرة الدولية: أنشأنا برك تثبيت ومعالجة للنفايات السائلة وتُعد حلًّا مبتكرًا يتناسب مع طبيعة مأرب
من جانبه قال أحمد الآشول، مسؤول قسم الاعلام والاتصال في المنظمة الدولية للهجرة، إنهم ينفذون برامج متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في مواقع النزوح والمجتمعات المستضيفة تشمل ‹جمع النفايات ونقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص الآمن منها›.
وفي مواجهة تحديات عدم وجود شبكات الصرف الصحي في مأرب، قال الأشول في تصريح لـ‹ريف اليمن› إن المنظمة أنشأت ‹برك تثبيت ومعالجة للنفايات السائلة› وتُعد حلًّا مبتكرًا يتناسب مع طبيعة مأرب بمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها ‹لري الأشجار على جوانب الطرق مما يعزز الفائدة البيئية المستدامة›.
وأعتبر المسؤول في الهجرة الدولية أن ‹إنشاء برك المعالجة والمناصرة لمشاريع إعادة التدوير يمثل تحولًا استراتيجيًا من الاستجابة الطارئة إلى حلول بيئية طويلة الأمد›، ولفت أن المنظمة تعتمد نهجًا متعدد الجوانب ‹يجمع بين تقديم الخدمات المباشرة، وبناء القدرات المؤسسية، والمناصرة الاستراتيجية›.
وعن أبرز التحديات ‹محدودية التمويل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، ونقص البنية التحتية لمعالجة النفايات› بالإضافة إلى ‹تغيير السلوك المجتمعي› والذي يتطلب وقتًا وجهودًا طويلة المدى. وفق الأشول.
من جانبه قال مساعد مدير تنفيذية النازحين في مأرب خالد الشجني: رغم الدعم الذي تقدمه المنظمات إلا أن ‹الفجوة ما تزال كبيرة جدًا› مؤكدا على ضرورة تنفيذ ‹مشروع صرف صحي متكامل لإنقاذ المحافظة وتفادي كارثة يصعب السيطرة عليها›.
في خضم هذه المعاناة الممتدة بين الصفيح والخيام، تبقى الحمّامات المؤقتة وأزمة الصرف الصحي شاهدًا حيًّا على مأساة النزوح في اليمن بعد نحو 12 عاماَ من إندلاع الصراع حيث لم توفر كل التدخلات حلولاً آمنه لليمنين الذين فقدوا منازلهم، ومازالت الأزمة مستمرة.