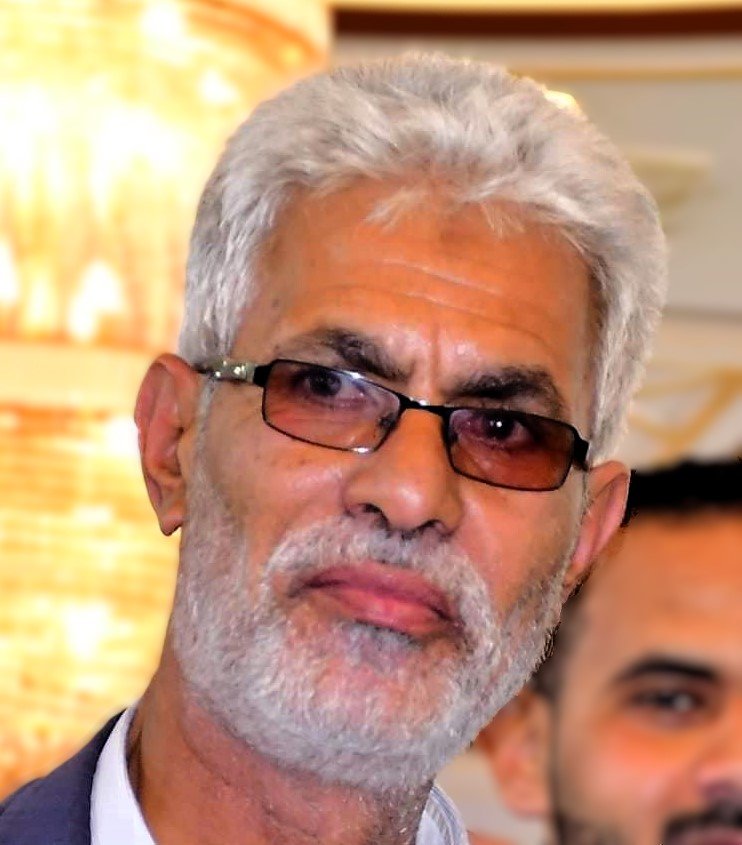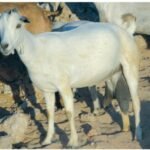الماء هو أساس الحياة، وبدونه لا يمكن تصور وجود الإنسان ولا استقرار المجتمعات، إنه جوهر التنمية المستدامة، وحجر الزاوية للاقتصاد، والشرط الأول لأي عملية إنتاج زراعي أو صناعي، ويشكل الماء العصب الحيوي لملايين الأسر في الأرياف التي تعتمد عليه لزراعة محاصيلها وتربية مواشيها، وهو في الوقت ذاته الركيزة التي توفر الغذاء لسكان المدن وتضمن استمرارية الحياة فيها.
ومع أن الماء يُنظر إليه عادة باعتباره رمزاً للخصب والنماء، فإنه قد يتحول إلى مصدر للموت والدمار والفقر إذا عجزت المجتمعات عن إدارته، سواء في صورة فيضانات جارفة تدمر القرى والمدرجات، أو أوبئة مميتة تنتشر عبر المياه الملوثة، أو موجات جفاف قاسية تدفع الناس إلى النزوح وترك أراضيهم. لهذا ظلّت مسألة تنظيم المياه والسيطرة عليها عبر القوانين والهياكل والمؤسسات، من أقدم أشكال الصراع الإيجابي الذي خاضته البشرية على مر العصور.
لقد ارتبط تاريخ الحضارات بقدرتها على التحكم في الموارد المائية، فحيثما وُجدت أنظمة إدارة متقدمة وحوكمة عادلة للمياه، ازدهرت المجتمعات، وحين فشلت في ذلك انهارت دول وإمبراطوريات بأكملها، واليمن لم يكن استثناءً من هذه القاعدة.
إدارة الطلب على المياه
منذ قرون طويلة وموقع اليمن جزء من المناطق الجافة وشبه الجافة، ومع ذلك لم تكن هذه الحقيقة عائقاً أمام الأجداد، بل دافعاً لإبداع أنظمة دقيقة في توزيع المياه عبر قوانين عرفية، وسدود صغيرة، وبرك حصاد، وترتيبات اجتماعية قلّلت من النزاع وأمّنت الحد الأدنى من الإنصاف.
كان التركيز على إدارة الطلب، لا الإسراف في العرض، فحافظوا على توازن جيد بين ما ينزل من السماء وما يستهلكه الناس، لكن هذا الإرث من الحكمة بدأ يتلاشى في الوقت الراهن وتحديدا من 1970 وما تلاها من سنوات، حين فشلت الحكومات والمجتمعات في المحافظة على ذلك التوازن التاريخي بين الموارد المائية المتجددة والاستهلاك السنوي؛ فتحوّلت اليمن من نموذج في إدارة الشح المائي إلى ساحة لاستنزاف غير مسبوق يهدد حياة الأجيال القادمة.

لكن الواقع في اليمن اليوم يكشف عن صورة مأساوية لهذا المورد الذي كان رمزاً للحياة، أكثر من ستة عشر مليون يمني يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة، وهو رقم يضع البلاد بين أكثر الدول معاناة من شحة المياه في العالم. وقد شهد اليمن بين عامي 2017 و2018 تفشي أكبر وباء للكوليرا في التاريخ المعاصر، نتيجة اعتماد ملايين السكان على مصادر مائية ملوثة.
الأطفال هم الأكثر هشاشة أمام هذه الأزمة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 297 ألف طفل دون الخامسة مهددون بالوفاة سنوياً بحلول عام 2040 في المناطق التي تعاني من أعلى مستويات الإجهاد المائي. كما أن شحة المياه أسهمت في تأجيج النزاعات المحلية على الآبار والموارد، وأدت إلى موجات نزوح داخلي من القرى إلى المدن، أو إلى مناطق أكثر وفرة بالمياه.
أما النساء والفتيات فهن يحملن العبء الأكبر يومياً، إذ يُضطررن إلى السير لمسافات طويلة لجلب المياه من مصادر نائية، ما يعرضهن لمخاطر جسدية ويقيّد فرصهن في التعليم والعمل. وهكذا تحولت قضية المياه في اليمن من تحدٍّ بيئي أو اقتصادي إلى أزمة إنسانية شاملة، تهدد الحياة الكريمة وتضع المجتمع بأسره أمام اختبار وجودي عسير.
نقطة التحول إلى الأسوأ
رغم أن الموارد المائية في اليمن كانت وما زالت شحيحة، فإن الأجداد تمكنوا بوعيهم الفطري وحكمتهم العملية من إيجاد توازن دقيق بين ما ينزل من السماء وما يستهلكونه سنوياً. لقد كانوا، دون مبالغة، بمثابة علماء ومهندسين في إدارة الطلب على المياه. فالزراعة اعتمدت لقرون على الأمطار، وخاصة في زراعة الحبوب، بينما بقيت الزراعة المروية محدودة جداً، وكان مصدرها العيون والغيول والسيول الموسمية، لا الآبار.
لكن التحول المفصلي حدث في سبعينيات القرن الماضي. إذ لم يستخدم اليمنيون مياه الآبار لري المحاصيل إلا مع دخول مضخات رفع المياه عام 1970. ومع أن الآبار السطحية التي حُفرت بالأيدي لم تكن خطراً على مستقبل المياه، فهي كانت تجف في منتصف مواسم الجفاف ثم تُعاد تغذيتها طبيعياً بمياه الأمطار، إلا أن إدخال تقنيات الحفر العميق مثّل بداية الكارثة الكبرى.
توسعت الأراضي المروية خلال 20 عاماً (1970 – 1990) بمقدار خمسة عشر ضعفاً، وهو نمو لم يواكبه أي حساب علمي لموازنة الموارد
فتحت هذه التقنية أبواب المخزون الجوفي العميق، وهو ماء تراكم عبر مئات السنين وكان من المفترض أن يُحفظ كرصيد استراتيجي للشرب في مواجهة المستقبل. لم يدرك الكثيرون أن استنزافه للزراعة يعني حرمان الأجيال القادمة من أبسط حقوقها في الحياة.
شيئاً فشيئاً، توسّع الحفر حتى بلغ عدد الآبار الجوفية في اليمن مئة ألف بئر، ومع تدفق المياه الوفيرة انتشرت الزراعة المروية وتراجعت الزراعة المطرية. عند هذه اللحظة بدأ الخلل الكبير: الاستهلاك تجاوز الموارد المتجددة بأكثر من ثلاثة أضعاف. لقد أصبح الوضع أشبه بتاجر ينفق أكثر من دخله عاماً بعد عام حتى يصل إلى الإفلاس الكامل. وللتوضيح، فقد توسعت الأراضي المروية خلال 20 عاماً أواخر القرن الماضي (1970 – 1990) بمقدار خمسة عشر ضعفاً، وهو نمو لم يواكبه أي حساب علمي لموازنة الموارد.
ما زاد الأمر سوءاً أن الحكومات في تلك الفترة تبنت سياسات قصيرة النظر، فدعمت حفر الآبار واستصلاح الأراضي الهامشية عبر قروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني الزراعي. وتحت شعار التنمية الزراعية، انتشرت عمليات الحفر العشوائي والتعميق حتى جفت بعض الآبار، بينما وصل عمق بعضها الآخر إلى ألف متر تحت الأرض. ولم تكتف الدولة بذلك، بل دعمت أسعار الديزل من الموازنة العامة، فكان المزارع يشتريه بثلث قيمته في السوق العالمية. هذا الدعم جعل الضخ المفرط بلا حساب ممارسة يومية، لا عائق مالياً أمامها.
وأصبح حفر الآبار في تلك الحقبة أسهل من أي وقت مضى. يكفي أن يمتلك المزارع بعض المال أو قليلاً من المجوهرات ليحفر عشرات الآبار ويبيع المياه للآخرين بلا رقيب، ومن لم يجد فسيحصل على قرض بنكي، بل إن الحكومة كانت تعتبره نموذجاً للمزارع المثالي الذي يقدم “خدمة جليلة” للوطن، بينما كان في الحقيقة يستنزف أثمن مورد للأجيال القادمة.
مع مرور الوقت، ساعدت الدراسات الممولة من المنظمات الدولية والمانحين على كشف حجم الخلل، وأظهرت خطورة الانخفاض المستمر في مستويات المياه الجوفية داخل الأحواض الرئيسة. ومع ذلك، لم تتحرك الدولة إلا بعد فوات الأوان، فأصدرت قانون المياه عام 2002 وفرضت التصاريح والرسوم على حفر الآبار. لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، والأحواض الكبرى دخلت مرحلة الخطر.
هكذا تحولت كل محاولة لمعالجة أزمة المياه إلى خطوة أعمق في مسار التدهور، لأن القرارات كانت تُتخذ ارتجالاً وبلا دراسة، ولأن الحكومات والمجتمعات فشلت في الحفاظ على الموازنة التاريخية بين الموارد المتجددة والاحتياجات السنوية.
من إدارة المورد إلى حوكمة عادلة
لقد أثبتت التجربة أن حفر آبار أعمق أو استحداث تقنيات جديدة للضخ لا يشكلان حلاً للأزمة، بل على العكس قد تزيد من تعقيدها، فما تعانيه اليمن اليوم ليس ندرة طبيعية فقط، وإنما أزمة حوكمة بالدرجة الأولى. المشكلة الحقيقية تكمن في غياب نظام إداري رشيد قادر على تنظيم الموارد، وفي ضعف المؤسسات التي لم تستطع فرض التوازن بين الاستهلاك والموارد المتجددة.
إن الحل يبدأ من إعادة تعريف المياه باعتبارها مورداً مشتركاً، لا ملكية فردية. الأحواض المائية ينبغي أن تُدار كوحدات متكاملة، بعيداً عن الحدود الإدارية الضيقة التي أدت إلى تضارب السياسات. هذا النهج هو ما أوصت به الدراسات الحديثة، التي أكدت أن كل حوض مائي يشكل نظاماً بيئياً واجتماعياً واقتصادياً متكاملاً، وأي استنزاف في جزء منه يؤثر على بقية مكوناته.
أثبتت التجربة أن حفر آبار أعمق أو استحداث تقنيات جديدة للضخ لا يشكلان حلاً للأزمة، بل على العكس قد تزيد من تعقيدها
كما أن تأسيس قاعدة بيانات وطنية للمياه لم يعد ترفاً، بل ضرورة وجودية. فغياب الأرقام الدقيقة جعل التخطيط في العقود الماضية مجرد اجتهادات ارتجالية، وأدى إلى تضارب القرارات بين الوزارات والهيئات. إن تحديث هذه البيانات بشكل دوري وإتاحتها للباحثين وصناع القرار والمجتمعات المحلية شرط أساسي لأي إصلاح جاد.
والحوكمة الرشيدة لا تعني فقط أن تضع الدولة القوانين، بل أن تضمن مشاركة الناس في صياغتها وتنفيذها. إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية في وضع الخطط المائية وتحديد أولويات الحصاد والري والرقابة يعزز العدالة ويمنح القرارات شرعية اجتماعية. لقد أثبتت التجارب أن القوانين التي لا تنبع من حاجات الناس ولا تراعي مشاركتهم، تبقى حبراً على ورق.
إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة إلى تشريعات صارمة تُطبَّق بجدية، تستند إلى مبدأ “المستخدم يدفع” و”الملوث يدفع”، لردع الاستهلاك المفرط والتلويث المتعمد. هذه القاعدة البسيطة من شأنها أن تُعيد الانضباط إلى قطاع المياه، وتكبح جماح الفوضى التي سمحت للبعض باستنزاف الموارد بلا رادع.
لا بد من العودة إلى دعم الزراعة المطرية وتشجيع تقنيات حصاد المياه التي خبرها اليمنيون منذ آلاف السنين
أما من حيث الممارسات الزراعية، فلا بد من العودة إلى دعم الزراعة المطرية، وتشجيع تقنيات حصاد المياه التي خبرها اليمنيون منذ آلاف السنين: السدود الصغيرة، الحواجز الترابية، المدرجات الجبلية، والبرك الموسمية التي تعيد تغذية المياه الجوفية. هذه الحلول أثبتت فعاليتها على مر القرون، وما تحتاجه اليوم هو التحديث والدمج مع المعرفة العلمية الحديثة.
الحوكمة العادلة للمياه لا تعني فقط ضبط الاستهلاك، بل تعني بناء عقد اجتماعي جديد حول هذا المورد الحيوي، يقوم على الشفافية والمساءلة والمشاركة. وهذا ما تفتقر إليه اليمن حالياً، حيث تظل القرارات مركزية، آنية، ومرتبطة بردود أفعال قصيرة المدى.
ختاما.. أزمة المياه في اليمن لم تعد مجرد قضية موارد طبيعية، بل تحولت إلى قضية بقاء إنساني تمس حياة كل أسرة ومصير كل جيل. إن الاستمرار في السياسات الارتجالية والقرارات العشوائية يعني المزيد من النزاعات على الموارد، وموجات نزوح أوسع، وانهياراً اجتماعياً واقتصادياً قد يصعب احتواؤه.
إن الطريق الوحيد للخروج من هذا النفق يتمثل في الجمع بين حكمة الأجداد الذين نجحوا في إدارة الشح، وبين حوكمة رشيدة ومعاصرة تعيد التوازن بين الاستهلاك والتجدد، وتضع الموارد المائية في قلب أي خطة للتنمية والاستقرار. بذلك وحده يمكن حماية المورد الأثمن في أرض سبأ، وضمان حق الأجيال القادمة في الحياة.