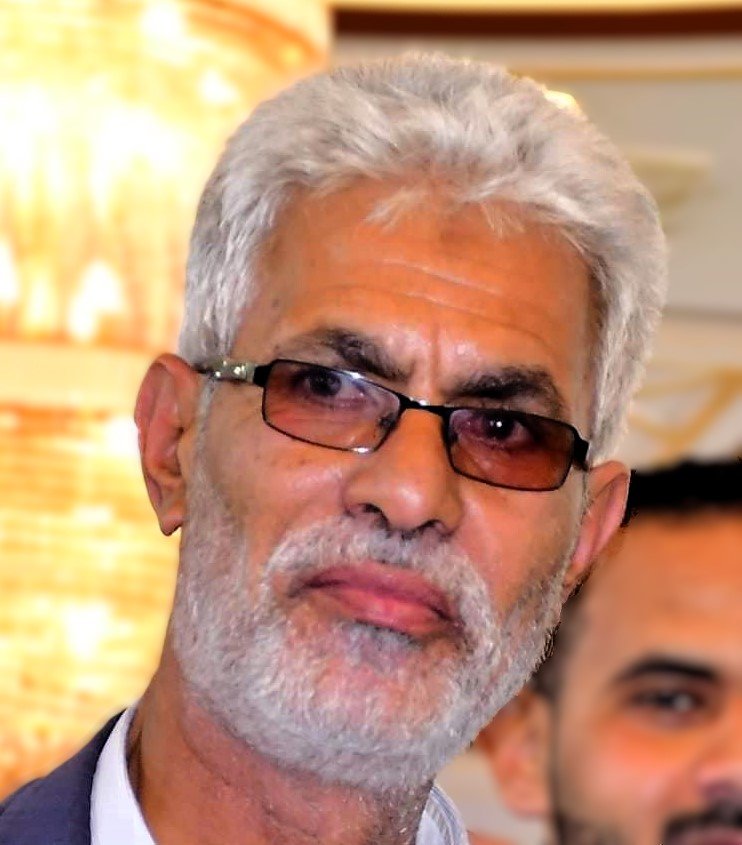في خضم ما نشهده اليوم من أزمات إسكانية خانقة، وتخبُّط في أنماط التخطيط الحضري، يثور سؤال جوهري: هل كان الماضي أكثر حكمة في تصميم المدن والمساكن مما نحن عليه الآن؟ وهل فاتنا أن نستلهم من أسلافنا حلولا تكاملية لمشكلات باتت تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المعاصرة؟
إن الهدف من هذه المقالة ليس تمجيد الماضي لمجرد كونه ماضيا، ولا الانتقاص من الحداثة لمجرد كونها معاصرة، بل الوقوف على مفترق الطرق بين نماذج عمرانية متجذرة في البيئة ومتكيفة معها، وأخرى منفصلة عن السياق الاجتماعي والبيئي، خضعت لسلطة السوق وتكتيكات الربح السريع.
- أولاً: من الاكتفاء إلى الاستهلاك
في النموذج التقليدي، لم يكن البيت مجرد مأوى، بل كان وحدة إنتاجية متكاملة وُظفت فيه كل المساحات بذكاء لخدمة الإنسان: جزء للسكن، وآخر للزراعة، وثالث لتربية الحيوانات.
كان البيت ينتج الغذاء، ويعالج النفايات، ويحقق الاكتفاء الذاتي. أما اليوم، فقد غلب على المشهد العمراني طابع استهلاكي بحت، ألغى البعد الإنتاجي للمنزل، وجرّد الساكن من أدوات الاعتماد على الذات.
- ثانياً: الفراغات التي تحاكي الحياة
المباني التقليدية لم تكن عشوائية، بل محكومة بتقسيمات مدروسة وظيفيا وروحيا. كانت هناك “السقيفة” و”الخلوة” و”السمسرة” و”المتبان” و”المشاقير”، وجميعها تشكل دورة حياتية متكاملة، تنظم علاقة الإنسان بالطبيعة، والزمان والمكان.
اليوم، باتت المساكن تفتقر لتلك الفضاءات المتعددة الوظائف، فاقتصرت على غرف نوم وصالات، واختُزلت الحياة اليومية إلى استهلاك معلب لا يمتّ بصلة للسياق البيئي أو الاجتماعي.
- ثالثاً: مواد البناء.. بين الطبيعة والاستيراد
من الطين والحجر إلى الأسمنت والحديد، تبدلت المواد، ومعها تبدلت الفلسفة؛ اعتمدت البيوت التقليدية على مواد محلية قابلة للتحلل والتدوير، وتُعطي شعورا بالانتماء للبيئة. أما اليوم، فالبناء يعتمد على مواد مستوردة مرتفعة التكلفة، تفرض تبعية للأسواق الخارجية، وتزيد من البصمة الكربونية للمباني.
والنظام الإنشائي تقليديا، اعتمد على الجدران الحاملة والعقود، حيث البساطة تلتقي بالكفاءة. في المقابل، يسيطر في العصر الحديث النموذج الخرساني المسلح، دون مراعاة لتكلفته البيئية، أو حتى مدى ملاءمته للمناخ المحلي.
- رابعاً: تناغم العمارة مع الطبيعة
كان اختيار موقع البناء في الماضي يخضع لحسابات دقيقة: اتجاه الرياح، مسار الشمس، خطورة السيول، طبيعة التربة. أما الآن، فالمعايير البيئية تذوب أمام ضغوط الاستثمار العقاري: نوافذ دون تهوية، مبانٍ متلاصقة دون فراغات، وانتشار عشوائي يجرف معه كل ما تبقى من علاقة بين الإنسان وبيئته.
في الماضي، كانت هناك “مقاطير” لتهوية المطابخ، و”زرب” لتدوير النفايات، و”نوافذ محورية” تفتح وتغلق حسب الحاجة، بينما اليوم تُترك مهمة التهوية والإضاءة لمكيفات مستوردة ومصابيح اصطناعية… و”فاتورة كهرباء” لا ترحم.
النتيجة: هل نحن في أزمة هوية عمرانية؟
أزمة السكن ليست مجرد نقص وحدات أو تضخم أسعار، بل هي انعكاس لفقدان البوصلة العمرانية. لقد بنينا مدنا لا تعبر عنا، بل تستنسخ أنماطا لا تناسب بيئتنا ولا ثقافتنا.
بينما في العمارة التقليدية، كان المهندس الشعبي يعرف كيف يزاوج بين الذكاء الاقتصادي، والمعرفة البيئية، والحس الجمالي.
توصيات من صميم الأزمة:
- البحث في التراث العمراني المحلي لاستخلاص حلول واقعية ومجربة، قادرة على التكيف مع المناخ والواقع الاقتصادي.
- دمج العمارة التقليدية بالتكنولوجيا الحديثة لخلق نماذج هجينة مستدامة وفعّالة
- إعادة النظر في السياسات العمرانية لتصبح أكثر عدلا في توزيع الأراضي، وتشجيع الأنماط السكنية المتكاملة.
- إدراج نماذج التخطيط التقليدي في مناهج التعليم المعماري، لا كمادة تراثية، بل كحكمة قابلة للتنفيذ المعاصر.
في الختام.. الحديث عن التخطيط الحضري ليس ترفا فكريا، بل ضرورة حيوية. وإذا لم نُعد التفكير في مدننا ومبانينا، فقد نجد أنفسنا ندفع ثمن الحداثة دون أن نجني ثمارها.
فهل آن الأوان أن نعود إلى الجذور لننطلق نحو المستقبل؟ أم أننا ما زلنا نؤمن أن الخرسانة وحدها تبني حضارة؟
*خاص بمنصة ريف اليمن